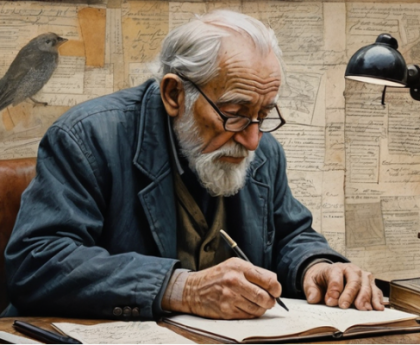عندما تطورت الهواتف النقالة قبل أعوام مضت، وانتقلت من أداء وظائفها الأساسية المتمثلة في تأمين المكالمات والرسائل النصية، لتشمل وظائف أوسع وأكثر ترفا كخاصية التصوير، كان إخراج صورة شخصية للوجود يتطلب شخصين على الأقل، أحدهما مصــّوِر والآخر موضوع للتصوير. وفي أسوإ الحالات، كان إخراج تلك الصورة، وإن بجودة أقل، يتطلب شخصا واحدا يؤدي دور المُصَـــّوِر والمصــوَّر بطريقة عفا عنها الزمن وتدعو اليوم للضحك وللسخرية.
حينها، كان على الراغب في التقاط صورة للذكرى أن يثبت وجه الهاتف على ظهر وسادة نوم أو كأس قهوة أو قنينة ماء إن وُجدت. وكان عليه بالإضافة إلى ذلك، أن يقوم ببرمجة زمنية لآلة التصوير على هاتفه، لتُلتَقط الصورة الموعودة بعد ثوان من الضغط على زر التصوير، يكون قبلها قد هرول إلى مكان ما، متخذا وضعية فيها كثير من الفوضى وقليل من الراحة.
في ذلك الزمن، وبعيدا عن المثال الأخير، كانت الصورة التي يلتقطها شخص ما لشخص آخر نتاجا لعملية إنتاج غير بريئة، بطلها في الغالب؛ مُصَـــّوِر يستمد شرعيته من عدسة الهاتف الذي في يده، ليمارس من خلالها سلطة البناء والهدم، والأمر والنهي، والتأكيد والنفي على الشخص المصوَّر لحظتَها، وعلى جمهور الصورة لاحقا، بكل شطط وعن سبق إصرار وترصد.
في هذا الموقف، وأثناء لحظة التصوير ، كانت للمُصَـــّوِر سلطة تحديد ما يجب أن يدخل في الإطار معززا مكرما، وما يجب أن يخرج منه مذموما مدحورا. كما كانت له سلطة التحكم في هيئة الشخص موضوع التصوير، في تعابير وجهه، وتفاصيل شعره، وحركاته وسكناته. فيأمره بالوقوف تارة، وبالجلوس تارة أخرى، وبالتبسم مرة، وبالتجهم مرة أخرى، وقس على ذلك.
أمام هذا الوضع، كانت حرية المصوَّر مكبلة كعصفور في قفص، وكان عليه أن يتقبل الصورة المنتجة كيفما بدت له، مُكرها لا بطلا. وإن لم يفعل، كان أقصى ما يطلبه أن يعاد أخذ الصورة له، فيغير شكل الخلفية والأكسسوارات إن وجدت، ويبدل هيئته الجسدية وتعابير وجهه ما أمكن، وكله أمل في أن يخرج بنتيجة أفضل من سابقتها. أما جمهور الصورة فما كان له إلا أن يتقبلها كحقيقة مطلقة، ويعتبرها انعكاسا طبيعيا لهيئة المصوَّر، وترجمة عفوية لشخصيته وللبيئة التي التقطت فيها، بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة.
ومثلما جرت به سنن الكون في كل مكان وزمان، ما كان لسلطة المُصَـــّوِر أن تستمر دونما نهاية، وما كان لخضوع المصوَّر أن يتواصل دون مقاومة أو تحرك. وهو وضع وَعَتْهُ شركات الهواتف النقالة بعد حين، فاستغلته لغايات تجارية محضة، وأنتجت لأجله هواتف نقالة بكاميرا إضافية في الأمام، تسمح للمستعملين بتصوير أنفسهم دون الحاجة لطرف ثان أو ثالث أو عاشر. وبذلك، انقلبت موازين القوى، فتخلص المصــوَّر من سلطة المُصَـــّوِر، وتحول هذا الأخير إلى مخلوع يمارس سلطته على نفسه دون غيره.
وفي ظل هذا التغير الجذري، كان الإحساس بالانتصار لدى المصوَّر يكبر ويتعاظم، وكان شعوره بالاستقلالية يزداد ويتفاقم، وكانت ذاته التواقة للحرية راضية كل الرضى، ولسانها يلهج بالشكر على نعمة التقنية الجديدة المسماة “سيلفي”، والتي شاع ذكرها في الآفاق، لدرجة اختيارها ككلمة السنة من طرف قواميس أوكسفورد عام 2013، واعتمادها بشكل رسمي في النسخ الإلكترونية لهذه القواميس.
في العهد الجديد إذن، توارت سلطة المُصَـــّوِر خلف عدسة السيلفي، تاركة مقاليدها لمن كان بالأمس ضحيتَها، وصار اليوم يرى أنه سيد نفسه وقائد ذاته، يلتقط له الصور متى شاء وأينما شاء وكيفما شاء. فيُدخِل في الإطار ما طاب له من عناصر، ويُخرج منه ما لم يطب؛ ويتخذ لنفسه الهيئة التي ترضيه، ويرغب عن غيرها؛ ويبتسم في وجه الكاميرا إن هو أراد ذلك، ويعبس إن لم يرد؛ وكله يقين أنه الآن “حر،” وأن “السيلفي” بعد تقاسمها مع الناس صورة “عفوية وبريئة”، لا بناء فيها ولا هدم؛ لا أمر فيها ولا نهي؛ لا تأكيد فيها ولا نفي !فهل هي حقا كذلك؟